الأمارات العربية المتحدة - ابوظبي


فنّانٌ جوّالٌ، وممثّلٌ، ومُغنٍّ، وبهلوانٌ، ومُهرّجٌ، ومُستفزٌّ، وغامضٌ، ومتمرّدٌ، ولمصافحته أثرٌ كملمس الشيطان، وابتسامته تشقّ الغيوم، يراقبك دائماً، ولا تراه حين تلتفت إليه، لكنّ حياتك لنْ تعود كما كانت. قضى طفولته في قريةٍ ألمانيّةٍ عاديّةٍ، محاولاً التوازن على أيّ حبلٍ يراه، إلى أنْ اضطّرّ إلى الهرب؛ لأنّ أباه الذي كان طحّاناً، وخيميائيّاً، وباحثاً عن خفايا الدنيا، تورّط في نزاعٍ مع اليسوعيّين. يتجول مع ابنة خبّاز القرية، يجوب القرى مخادعاً الموت، وفي ساحات المعارك يركض أسرع من قذائف المدفعيّة، ويمارس ألاعيبه في الغابات المظلمة التي تتجوّل العفاريت فيها، وفي رحلته التي يجوب فيها البلاد التي مزّقتها حرب الثلاثين عاماً يقابل الكثيرين: الكاتب فولكنشتاين الراغب في التّعرُّف إلى الحرب عن قُرْب، والجلّاد المكتئب تيلمَن، ولاعب الخِفّة بيرمين، والحمار النّاطق أوريغينِس، وملك وملكة الشتاء المنفيّين: فريدريش الألماني، وليز الإنجليزيّة، الّلذَيْن كانا السّبب المباشر في اندلاع حربٍ غيّرت أوروبّا، والشّاعر الطّبيب باول فلِمينغ، المُصرّ على كتابة الشِّعر بالألمانيّة البدائيّة التي لا يفهمها أحد، والمتعصّب تِزيموند، وعالِم التنانين الحكيم أتَنازيوس كيرشر؛ الذين تلتقي مصائرهم جميعاً في أنّهم قابلوا يوماً تلك الشّخصيّة الغامضة التي تقرّر ذات يومٍ أنّها لنْ تموت، بطلَ العصور كلّها: تيل أولِنشْبيغل.

يرى التّصوّر التّقليدي أنّ المجرمين قد خالفوا النّظام الاجتماعيّ، والسّلام العام؛ ولذلك فإنّه يجب أن يُعاقبوا علانيةً، فوجود المتفرّجين يؤكّد على حُكم القاضي ويُسوّغه من جهة، ويحقّق هدف السُّلطة في ردع الآخرين عن تكرار الجريمة من جهةٍ أُخرى، وهذا الردع لا يأتي من الخوف من الأذى البدنيّ للعقوبة فحسب، بل من الخوف من الشعور بالخِزْي والعار، الذي لا يتحقّق إلّا بوجود شهودٍ على الإذلال الحاصل. لكن كيف تتشكّل المجتمعات التي تقبل مثل تلك الممارسات، أو حتّى تطالب بها؟ وما الأنظمة السّياسيّة التي تسمح بالإذلال، وما الأنظمة التي تحاول منعه؟ وهل يمكننا القول: إنّ الإذلال مرتبطٌ بفترة "العصور الوسطى المظلمة" فقط أم إنّ الحداثة "السّاطعة"، والمنيرة، والمتنوّرة قد جلبت معها أساليبَ جديدةً للخِزْي خاصّةً بها، واخترعت ممارساتٍ جديدةً للإذلال؟ في تحليلٍ مذهلٍ للأحداث التاريخيّة والمعاصرة، تُظهر المؤرّخة الألمانيّة أوتا فريفرت الدور الذي لعبه الإذلال في بناء المجتمع الحديث، وكيف استُعمل الإذلال والشعور بالعار الذي يولّده كوسيلةٍ للسيطرة، من عوالم السياسة إلى التعليم المدرسيّ، وأنّ فنّ الإذلال ليس شيئاً من الماضي فحسب، بل تطوّر ليناسب تغيّرات القرن الحادي والعشرين، في عالمٍ لا يكون الإذلال فيه من القوى السياسيّة التي تسيطر علينا فقط، إنّما من قِبَل أقراننا أيضاً.

ما الحرب من دون صيحات المتظاهرين، وهدير الطائرات الحربيّة، وصراخ المعتقلين في غرف التعذيب؟ وكيف تتبدّى الموجودات والأفعال من دون أصواتها؟ وما الحاجة إلى جرس الباب؟ وما صوت الطعام المطهوّ في قِدْرٍ؟ وكيف يستطيع الطفل-الشابّ الأصمُّ هضْم عالمٍ صامتٍ، مكتوم الصوت كهذا؟ تلك بعض الأسئلة التي يطرحها كتاب "المريد الأصمّ"، الذي يصف صورة العالم بعد حذف ملفّه الصوتيّ، ويحكي يوميّات أبٍ قام بتنشئة ابنه الأصمّ وحيداً. متّكئاً على أساليبَ سرديّةٍ متنوّعةٍ، يُضيء ريبر يوسف على الجوانب المُعقّدة في ثنائيّة الأبوّة- البنوّة بما فيها من مشاعرَ مُركّبةٍ، مثل: الحُبّ، والكُره، والخوف، والرغبة في التحرُّر من عِبْء هذا الرابط بين الاثنين، أو الدفاع عنه وتعزيزه. هو كتابٌ عن الأب الذي يتخلّى طوعاً عن أصوات العالم إن كانت لا تطرق أذنَيّ ابنه، وعن ابنٍ يُعيد اكتشاف نفسه ليدفن صممه وخوفه إلى الأبد.

متنقلاً بين الزبلطاني، ودويلعة، وصيدنايا، وصولاً إلى إسطنبول، يروي أحمد أسْود -الخيّاط على ماكينة الدرزة- قصّة حياته كما تتبدّى له، حياة حافلة بالتحوّلات والتجارب الأولى: بداية الوقوع في الحُبّ، والسفر، والتخطيط لجريمة قتل. بلغةٍ خاصّةٍ قد تبدو حياديّةً، لكنّها ساخرةٌ ومفعمةٌ بالعاطفة، يستكشف وسيم الشرقي زوايا منسيّةً من حياة شريحةٍ مُهمّشةٍ من السوريّين قبل 2011، مثل: المهرّبين على الحدود اللبنانيّة، أو عمّال مصانع الخياطة، وروّاد نوادي كمال الأجسام وبارات دمشق القديمة. "أسْود" رحلةٌ للغوص في الدوافع والمحرّكات التي توجّه سلوك الأشخاص ومصائرهم، ومحاولةٌ لتتبُّع مصدر السواد الذي يغلّف حياتنا، ويستقرّ في نفوسنا، عصيّاً على الزوال.

متنقّلاً بين أسواق حلب الأثريّة وبين بارات برلين، يُعيد بطل رواية "أوراق برلين" اكتشاف نفسه مرّةً بعد مرّةٍ، ويفتح يديه لتجاربَ متنوّعةٍ، وأناسٍ جُدد، ويصيخ السمع منتظراً أن يقصّ عليه أحدهم حكايةً جديدةً كي يدوّنها، ونراه يهرب من قصّة حبٍ مخفقةٍ عبْر استكشاف تاريخ ألمانيا في الحربَيْن العالميّتيْن: الأولى، والثانية، ليضيع في الذكريات، والصور، والخرائط، بين حلب الغربيّة والشرقيّة وبين برلين الغربيّة والشرقيّة، ويقلّب في لوحات الرسّام الألمانيّ أوتو ديكس، التي جسّدت بشاعة الحرب العالميّة الأولى؛ كي ينسى صور الدمار والقتل التي احتفظت بها ذاكرته. يتجوّل نهاد سيريس في روايته بخفّةٍ بين الأماكن، والأشخاص، والأحداث، ضمن نصٍّ متدفّقٍ واحدٍ، ويتخفّى عمله وراء طابعٍ توثيقيٍّ ينقّب في تاريخ الحروب وعمارة المُدن، وبعدئذٍ يفاجئ القارئ بجرعةٍ غير متوقّعةٍ من الخيّال عن أعاجيب وقوى خارقة تُعين الناس على تجاوز ويلات الحرب هرباً نحو بداياتٍ جديدة. فهل يمكن للمرء الفرار من حربٍ في بلاده عبْر الغرق والتنقيب في تاريخ حربٍ أُخرى وقعت في زمانٍ ومكانٍ آخرين؟

بعد خمسة عشر عاماً على انقلابه العسكريّ، وسيطرته على الحُكم، يقرّر الجنرال بيونشه الاستجابة للضغوطات الشعبيّة والدوليّة، وإجراء استفتاءٍ رئاسيٍّ يحدّد مصيره، فيستدعي وزيرُ الداخليّة خبيرَ الإعلانات والمعتقل السابق أدريان بيتيني؛ لإقناعه بقيادة حملة إنجاح بيونشه، إلّا أنّ زعيم الائتلاف المعارض المُكوّن من ستّة عشر حزباً متنافراً يقترح على بيتيني فكرةً جنونيّةً: إدارة الحملة الانتخابيّة لحملة "لا" التي تتجسّد فقط في إعلانٍ تلفزيونيٍّ قصير. وعوضاً عن التركيز المعتاد على المجازر، والمعتقلين، وأهوال المرحلة الماضية، يقترح بيتيني أن يكون عنوان الحملة: الفرح آتٍ. فهل ينجح إعلانٌ من خمس عشرة دقيقةً في إسقاط حُكمٍ دكتاتوريٍّ دام خمسة عشر عاماً؟ بأسلوبٍ شاعريٍّ متفائلٍ، يحكي سكارميتا قصّة كفاحٍ حقيقيّةً عن الأمل والفرح، في أحلك الأوقات، في بلدٍ يتوق إلى الحريّة.

صوفيا طفلةٌ جريئةٌ وحادّة الطباع، بخلاف جدّتها التي ترعاها بعد وفاة والدتها. في كلّ صيفٍ تخوضان معاً مغامرةً جديدةً من نوعٍ مختلفٍ: كاستكشاف أجزاءٍ من الجزيرة التي تعيشان فيها، والتعرّف إلى أنواعٍ جديدةٍ من الطيور، والسباحة في الخليج الخطِر من دون عِلم والد صوفيا، والنوم في خيمةٍ، وبناء نموذجٍ مصغّرٍ لمدينة البندقيّة، وتأليف كتابٍ عن الحشرات. ومن دون التطرّق إلى حقيقة مشاعرهما، تمضيان يومهما في حواراتٍ ونقاشاتٍ لا تنتهي عن كلّ شيء: معنى الحياة والموت، وماهيّة الله والشيطان، والجنّة والجحيم، ومفاهيم الحُبّ، والعائلة، والصداقة، والتسامح. عبْر خلْق عالمٍ متكاملٍ في جزيرةٍ صغيرةٍ ومعزولةٍ، تكتب "توفه يانسون" -بأسلوبٍ سحريٍّ، وجُملٍ بسيطةٍ محمّلةٍ بمفاهيمَ عميقةٍ- روايةً عذبةً عن الصداقة التي تربط بين طفلةٍ تبدأ رحلتها في الحياة، وجدّتها التي تقترب من نهاية هذه الرحلة.
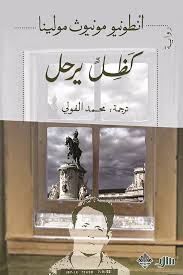
بعد أن اغتال "مارتن لوثر كينغ"، يستطيع "راي" الهروب بجواز سفر مزوّر، وفي أثناء تنقّلاته من بلدٍ إلى آخر ظلَّ يتابع الصحف مبتهجاً برؤية اسمه في قائمة "أخطر عشرة مجرمين مطلوبين للأف بي آي". يحطّ به ترحاله أخيراً في لشبونة حيث يمضي عشرة أيام منتظراً تأشيرة دخول إلى أنغولا. لكن لشبونة تلك كانت أيضاً المدينة التي ألهمت "أنطونيو مونيوث مولينا" روايته الأكثر شهرة، وعندما قرّر الآن كتابة رواية عن "راي" صارت المدينة شاهداً على ثلاث قصص متناوبة: رجل قاتل هارب من وجه العدالة، وكاتبٌ يكافح للعثور على صوته الأدبي، والكاتب نفسه بعد مرور ثلاثين عاماً يتأمل في حياته وحياة بطله وشكل الرواية التي يحاول أن يتخيّل فيها العالم بوعي رجل آخر. في "كظلٍّ يرحل" التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر الدولية في عام 2018، يكتب "مولينا" روايةً آسرة، وقويّة، ومليئة بالتفاصيل، دامجاً الحدث الروائي بكيفية الكتابة عنه.
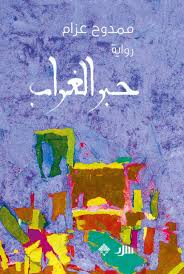
بعد أن فقد الأمل في إثبات وجود مكتبة السمّاقيات، التي اختفَت في ظروف غامضة في بدايات الستينيات، يظهر من العدم تقريباً واحدٌ من كتبها، بعيداً عن مكان وجودها واختفائها أكثر من عشرين كيلومتراً: كتاب "الشوقيّات" كاملاً، وعلى صفحته الداخلية كُتب "مكتبة السماقيات"، ووُضع رقم تسلسلي. هذا الكتاب يُحيي الأمل لدى "توفيق الخضرا" في إثبات وجود المكتبة، التي صارت بالفعل مكتبة خيالية لم يكن لها وجود قطّ، بسبب إنكار الجميع وجودها من الأساس. يبحث عن بقية الكتب، ويتتبّع كيف وصلت إلى الأشخاص الذين وجدها عندهم، ورويداً رويداً تنجلي أمامه وقائع ما حدث في ذلك اليوم البعيد، الذي اختفت فيه المكتبة وقُتل فيه "فارس أبو لوز".
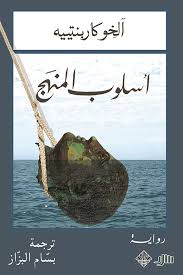
قصة ديكتاتور آخر من أميركا اللاتينية، إلا أنه في هذه الرواية ديكتاتور مثقف متنوّر، يصادق أكاديمياً وشاعراً وأديباً في باريس، ويحضر عروض الأوبرا، ويزيّن قصره باللوحات الفنية. لكنه على "علو ثقافته" فاسد مفسِد، يفعل كلّ شيء للبقاء في سدّة الحكم، فيحوك المؤامرات ويرسم المسرحيات، لأنه يعرف أنه من دون الكرسي لا يساوي شيئاً. أراد "كاربنتييه" أن يكون عنوان روايته "أسلوب المنهج" متناظراً مع عنوان كتاب ديكارت: "خطاب المنهج". وبينما يضع الفيلسوف نظريته عن المنهج ويداه في الماء البارد، فإن تطبيقها يظهر هنا ساخناً ملتهباً مسوماً بالحديد والدم والنار، فيعالج الكاتب الكوبيّ شخصية الطاغية من الداخل، متأملاً نفسيته، داخلاً إلى تلافيف عقله، بكتابةٍ جريئة في تصوّراتها، غنيّة بتفاصيلها الخصبة، ومبتكرة في تقنيات سردها.

"لست شتيلر!"، يبدأ بطل الرواية كتابته بهذه العبارة، ويسوِّد سبع كرّاسات في سبيل إثبات أنه ليس ذاك الذي يصرّ الجميع أنه هو. فيعترف بجرائم قتل لم تُحلّ، ويحكي تفاصيل حياته السابقة في المكسيك وأميركا بين رعاة البقر وعمّال الرصيف، ولكن مع ذلك فإن زوجة "شتيلر" وأصدقاءه وشقيقه يتمسّكون برأيهم، فيما بطل الرواية يكتب ما يقولونه في كرّاساته ويعلّق عليه، وعلى حياة ذلك النحّات، وعلاقاته العاطفية والزوجية، وعن الفن والفنّانين وتقلّبات حياتهم. تعتبر "شتيلر" إحدى الدرر الأدبية، ومن أهم الروايات المعاصرة المكتوبة بالألمانية. إنها رواية استثنائية عن الإنسان الحديث وعلاقته المتصدّعة مع الهوية، وعن صورة الذات لدى النفس ولدى الآخرين. وهي رواية مكتوبةٌ برهافة وببناء فني معقّد ومقنع وممتع في آن معاً، تُبرز المقدرة الفذّة للكاتب السويسري الشهير "ماكس فريش".

تبحث شخصيات هذه الرواية عن حياةٍ مختلفة، فتترك بعضهنّ عملهنّ في مصنع القطن ويتحوّلن إلى عاملات جنس في منتجع الينابيع الحارة، بينما يدخل واحدٌ منهم إلى السجن بإرادته باحثاً عن الهدوء، وتمضي ثالثة إلى مسقط رأسها مكتشفةً كهوفاً وأنفاقاً عجيبة، بينما تختار رابعةٌ ملاذاً لها في مقاطعة ريفية، حيث الأعشاب الصينية المستخدمة في الطب التقليدي. تتشابك هذه الشخصيات في علاقات عاطفية وجسدية متعددة، فيما يبدو كلّ واحدٍ منهم وكأنه مرآة للآخر، إذ تبدأ حكاية كلّ واحد منهم حيث توقفت السابقة، في بنيةٍ زمنية انسيابية. في هذه الرواية التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر الدولية عام 2019، تكتب "تسان شُيِّيِه" عن مغزى الحياة في علاقتها بالحب والجنس ومسقط الرأس والعمل، وعن الحدّ المتلاشي بين الحياة والموت، وبين اليقظة والنوم، في حبكة ضبابية وهائجة مليئة بأوصافٍ حسّية واستعاراتٍ حيّة، تتردّد في جوانبها أصداء الواقعية السحرية.

خالد شابٌّ ثلاثينيٌّ تخرّج في كليّة الفنون الجميلة، وأخفق في السفر من مدينته "الجنيّات" التي أطبقت الخناق عليه من كلّ الجهات، فلم يبق أمامه خيارٌ سوى العمل موظّفاً في مكتبة، يمارس من خلالها عملاً إضافيّاً سريّاً يبيع فيه أعماله الروائيّة. كانت الحياة لتسير بصورةٍ أفضل لو أنّ المرء يستطيع حفظ السرّ، لكنْ كما يقول فرج والد خالد: "مهما أخفيته، سيستيقظ السرّ في داخلك يوماً ما، حينها سيظلّ يحفر روحك حتّى يتحرّر منها إلى العالم". وبذلك فخيارات خالد في الحياة سرعان ما تضعه في مواجهة "خليل النايف" المحامي، صاحب النفوذ الواسع، والراغب في دخول عالم الكتابة. ضمن سياقٍ تشويقيٍّ، وإيقاعٍ متسارعٍ، يغوص تميم هنيدي في كواليس علاقات الكتّاب، والناشرين، وأصحاب المكتبات، ويضيء على الطريقة التي قد تُوظَّف فيها الثقافة لتلميع صورة الطبقة السياسيّة التي أفرزتها الحرب، لكنْ هل تستطيع الكتب القيام بمهمّةٍ مثل هذه؟

بيوت مُلْك، وأُخرى مستأجَرة، مساكنُ زائلةٌ ومؤقّتةٌ، تتنقّل بينها الكاتبة عابرةً مدناً سوريّةً مختلفةً، ومحيلةً المنازل إلى محطّاتٍ، أو استراحاتٍ تتيح لها تأمُّل سياق حياتها، وخياراتها، ومنبع رغبتها في البقاء بين الأبواب المغلقة. الطابع الذاتيّ للكتاب يُحيله إلى نوعٍ من الشهادة الشخصيّة، لكنّ نور أبو فرّاج تراهن على أنّ ذكرياتها قد تتقاطع إلى درجةٍ كبيرةٍ مع تجارب شباب وشابّات الطبقة الوسطى من جيل الثمانينيّات في سوريا، الذين عاشوا حياةً مستقرّةً نسبيّاً، قبل أن تأتي الحرب وتُحدِث قطعاً في سياقهم، وتطردهم قسراً من مساحاتهم الآمنة. في وجه الزوّال وعدم اليقين الذي تُحدِثه الحرب، يُمسي الوصف تخليداً للزائل؛ ولهذا يحاول الكتاب تذكير القُرّاء بالوقت الطويل الذي يلزم لبناء بيتٍ، بالمعنى الرمزيّ، أو الإنشائيّ، لكنّه مع ذلك يحذّرهم من أن يمسوا أسْرى للمكان، ويشجّعهم على حمل بيوتهم كتذكاراتٍ، أو أمتعةٍ صغيرةٍ في رحلتهم الطويلة.

لا تقدّم لنا "كريستينا فرناندث كوباس" بطلاتِها بسهولة، فهي تأخذنا في مسارات مستقيمة للوهلة الأولى، وفي لحظةٍ ما، تقلب كلّ شيء رأساً على عقب، فنكتشف أن شخصياتها تضطرب بين واقعَين، الفاصل بينهما دقيق جداً، هما الواقع الثابت، والواقع المُتخيّل أو الموهوم. يطغى أحدهما على الآخر تارةً، وتحدث مصالحة بينهما تارة أخرى، من غير أن ندري أيّهما الموجود الحقيقي، وأيّهما غير الموجود. "حجرة نونا" التي حازت جائزة النقّاد في إسبانيا (2015)، والجائزة الوطنية للسرد (2016)، عدسةٌ مكبّرة نرى فيها تعقيدات النفس البشرية والغموض الذي يلفّ حياتنا من دون أن ننجح في ملاحظته وفهمه دائماً، تعيد فيها "كوباس" النظر في الطفولة والنضج والوحدة والأسرة، لتكشف لنا أن لا شيء هو فعلياً كما يبدو، كاتبةً كلَّ ذلك بلغةٍ شفيفة وبأسلوب متفرّد تضفي عليه مسحةً بوليسية، بمهارة وخفّة.

أدخل عنوانك وسنحدد العروض لمنطقتك.